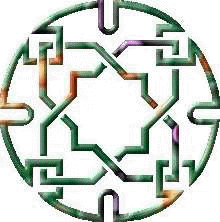
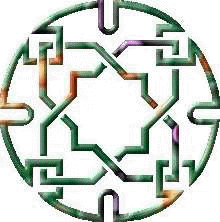


هل تمهد الهوية الثقافية
الطريق للوحدة السياسية العربية؟
رضوان السيد
مجلة العربي الكويتية - أول أكتوبر 2000
على الرغم من أن الهوية السياسية الواحدة لم تتحقق عربياً حتى الآن، فإن الهوية الثقافية بفضل مئات من المثقفين، أصبحت أمراً واقعاً.
روى التنوخي في كتابه: (الفرج بعد الشدة) أن عربياً أسره الروم في عهد معاوية، وأطلق سراحه بعد سنوات طوال أيام عبدالمك بن مروان، لقي في طريقه رومياً أثناء وجوده في الأسر يُتقن العربية، فظنّه من أصل عربي، فسأله: من أيّ العرب أنت? فضحك وقال: لست أعرف لمسألتك جواباً لأني لست عربياً، فأجيبك على سؤالك! فقال له العربي: مع هذه الفصاحة العربية? فقال الرومي: إن كان العلم باللسان ينقل الإنسان من جنسه إلى جنس من حفظ لسانه فأنت إذن رومي! فإن فصاحتك بلسان الروم ليست دون فصاحتي بلسان العرب، فعلى قياس قولك ينبغي أن تكون أنت رومياً وأكون أنا عربياً!
إنّ الواضح من هذه القصة أن الرجلين ما كانا يريان للغة مدخلاً في الهوية. لكن ربما ما كان مفهوم (اللغة الأم) قد انتشر في تلك الفترة المبكّرة من تاريخ الإسلام، أو أنّ القصة موضوعة للحيلولة دون انتساب الموالي للعرب الذين كان يبلغ بهم الإتقان للعربية أحياناً درجة يتجاوزون بها الكثير ممن كانت العربية لسانهم الأم، والحسن البصري - سيد فصحاء البصرة منذ مطالع النصف الثاني من القرن الأول الهجري - خير مثال على ذلك.
بيد أنني أوردت هذه الحكاية ليس من أجل لفت الانتباه إلى الاختلاف في موقع اللغة من الهوية في مجالنا الحضاري وحسب، بل وليكون ذلك مدخلاً لمقاربة مسألة الهوية ذاتها، التي يصعب تحديدها بحد جامع وناجز، وبخاصة لدى الأمم التاريخية مثل أمتنا العربية التي تبقى هويتها في حالة تحقق مستمر. ولذا فإنني آثرت أن أتابع بإيجاز تطور الأفهام العربية الوسيطة لمن هو العربي? وصراعهم حول ذلك، تمهيداً لبحث أسباب توهّج قضايا الهوية من جديد وعلائقها باللغة في مجالنا الثقافي المعاصر.
هناك احتمال - إذن - أن تكون قصة الرومي المتقن للعربية مخترعة لحرمان الموالي المقبلين على الإسلام والعربية، من شرف هذه النسبة واستحقاقاتها. على أن الأمر ما عاد احتمالاً عندما اشتعلت الصراعات على السلطتين السياسية والثقافية في العصر العباسي الأول. إذ المعروف أن الفرس أسهموا إسهامات بارزة في قيام دولة بني العبّاس، ثم إنهم بعد تصاعد نفوذهم في دواوين الدولة والبلاط، وقفوا إلى جانب المأمون في صراعه مع أخيه الأمين على السلطة بعد موت هارون الرشيد. وقد اتجهوا لدعم مواقعهم السياسية بالطرائق الثقافية والسياسية المتعارف عليها عندما استندوا إلى التسوية الإسلامية في ندّيتهم للعرب ضمن الإسلام والدولة الإسلامية. تذكـُر المصادر العربية في هذا الصدد أن المتحمّسين من كتّاب الديوان الأعاجم أطلقوا على أنفسهم لقب (أهل التسوية) وأطلق عليهم مجادلوهم من العرب اسم الشعوبية. أما الحجج الجدالية فتركّزت في الحقيقة على مكوّنات الهوية أو الذاتية العربية الإسلامية. أقدم النصوص التي تتعاطى مع اللغة في علاقتها بالهوية، تلك الفقرات الواردة في (الرسالة) للإمام الشافعي (-204هـ)، والتي تقدّس اللغة العربية باعتبارها لغة القرآن،(فكتاب الله محصن بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره)، وإنما أنزله الله بلسان العرب لأنه (أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها نظاماً). وبسبب الارتباط بين القرآن والعربية، صار هناك ارتباط بين الإسلام والعرب. لأن الرسول (صلى الله عليه وسلم) من أنفسهم، ولأنّ القرآن نزل بلسانهم. ثم يورد الشافعي عبارة شديدة الغموض، لكنها رغم ذلك شديدة الأهمية: (وإنما صار غيرهم من غير أهله بتركه، فإذا صار إليه صار من أهله): من غير أهل ماذا? اللسان أو الإسلام والقرآن? فإن يكن الأول: فإن الشافعي يعتبر أنّ اتخاذ العربية لساناً يجعل من المرء عربياً، والعكس بالعكس بغض النظر عن الجذور الإثنية. لكن الاحتمال الثاني وارد أيضاً. لكن أيّاً يكن الأمر فما يعنيه الشافعي أن اللغة العربيـة جزء أساسي أو محدد في الهوية العربية والإسلامية. أما الجاحظ (- 255هـ)، وابن قتيبة (- 276هـ) اللذان شاركا في مجادلة الشعوبية بشكل مباشر، فالظاهر أنهما ما كانا يعتبران اللغة عنصراً أوحد أو رئيسياً في تحديد الهوية، بل كانا يضيفان لذلك المسألة التاريخية (أصول الفرد)، والموطن (التأصل في الجزيرة)، والأخلاق والسجايا والأعراف (الشجاعة والكرم والحلم). ويظهر ذلك واضحاً في الآثار التي يوردها أحمد بن حنبل (-241هـ)، والتي تعتبر أن (جنس) العرب أفضل من (جنس) العجم، وإلا لما بعث الله نبيّه منهم، ولا خصّهم بتلك الأخلاق والسجايا المحمودة. ويذكر عنه تلميذه أحمد بن جعفر الإصطخري العبارة التالية: (..ونعرف للعرب حقّها وفضلها وسابقتها، ونحبّهم لحديث رسول الله (صلى الله عليه وسلم): حبّهم إيمان، وبغضهم نفاق. ولا نقول بقول الشعوبية وأراذل الموالي الذين لا يحبّون العرب..)، وهكذا فإن القرن الثالث الهجري شهد ظهور تيار يقول بوجود (أمة عربية) أو (جنس عربي) اللغة عنصر مهم في تكوينه، لكن هناك عناصر أخرى تاريخية وجغرافية وإثنية، تشكّل بمجموعها الهوية العربية.
أما كتّاب القرون الثلاثة اللاحقة، وبخاصة منهم ذوو النزعة الفلسفية، فقد اعتبروا العرب أمّة كبرى ضمن الأمم الخمس أو السبع أو التسع التي أسهمت في صنع تاريخ وحضارات العالم، لكن لا علاقة لرؤيتهم تلك بصراع العرب والعجم إذ كانت الظروف الثقافية والسياسية قد تغيّرت. واتخذت مفردات مثل الأمة أو الملّة معاني جديدة ذات أبعاد ثقافية وتاريخية لا علاقة مباشرة لها بالدولة وتوازناتها.
ويفاجئنا ابن تيمية (-728هـ)
بنظرية في الهوية العربية وتطوّرها التاريخي والمضموني. فاسم العرب - بحسبه
- كان يطلق على قوم جمعوا ثلاثة أمور: أن لسانهم كان اللغة العربية، وأنهم
كانوا من أولاد العرب، وأنّ مساكنهم كانت أرض العرب وهي جزيرة العرب. فلما
جاء الإسلام، وفُتحت الأمصار، انتشر العرب في سائر أصقاع الأرض، فانقسمت
البلاد التي سكنوها إلى قسمين: أولهما ما غلب على أهله لسان العرب.
وثانيهما ما غلبت على أهله العجمة. أما الأفراد فمنهم من صار لسانه
العربية، ومنهم من هو من أصل عربي وصار لسانه أعجمياً. وهنا يستظهر ابن
تيمية أن البلاد التي يغلب على سكّانها اللسان العربي هي بلاد عربية،
والأفراد الذين صارت العربية لسانهم الأمّ هم عرب وإن تكن أصولهم أعجمية،
والعكس صحيح: فمن كان من أصل قرشي واستعجم لسانه لسُكناه في أرض العجم ما
عاد يمكن أن يكون عربياً. على ذلك يستشهد ابن تيمية بالمأثور عن النبي (صلى
الله عليه وسلم): (إن العربية ليست لأحدكم بأب ولا أمّ إنما هي لسان، فمن
تكلّم العربية فهو عربي).
معيار الهوية
إنّ اللغة والهوية (أو جدليات العلاقة بينهما) ما كانتا المدخل للنقاش في المراحل الكلاسيكية والوسيطة، بل كان مدخل النقاش وباعثه: علاقة الشعوب المختلفة بالإسلام، وصولاً لاستخدام ذلك في الصراع على السلطة السياسية أولاً والثقافية ثانياً. فلمّا صار التنافس ثقافياً بحتاً بين أرباب القلم بعد إذ احتكـرت الشعـوب التركية (أرباب السيوف) السلطة - صار اللسان الحامل للثقافة هو المعيار الوحيد للهوية.
بدأت المرحلة الحديثة بالنسبة للعرب وهويتهم بالصراع من أجل البناء الذاتي والتمايز. ويمكن القول إنهم دُفعوا إلى ذلك دفعاً نتيجة الهجمة على اللغة العربية واللسان العربي. ويمكن التفريق في هذا الأمر بين حقبتين: حقبة الإصلاح الديني والسياسي من ضمن مشروع الدولة العثمانية للتجديد في عصر التنظيمات . وتتلو ذلك حقبة التمايز التي لعب فيها الانتماء دوراً ما لبث أن تزايد حتى بزوغ الإحساسات القومية عشية الحرب الأولى وبعدها.
في الحقبة الأولى جرت محاولات تجديد المشروع الديني، والمشروع السياسي في عملية البناء الذاتي: من خلال القاعدتين اللتين طرحهما الطهطاوي وخير الدين التونسي وهما: المنافع العمومية والتنظيمات، وما كان هناك وعي واضح بالخصوصيات والمحليات تحت سقف الرؤية الإسلامية الواسعة للدولة العثمانية. وفي حين ظلت الازدواجية اللغوية التركية/العربية مألوفة في التأليف والترجمة، ركّز أولئك الذين ابتعثهم محمد علي إلى فرنسا والشوام العاملون بمصر أو اسطنبول، ورجالات الإرساليات، على التأليف بالعربية، والترجمة إلى العربية. وقد كان ذلك مفيداً في ظهور تباشير لغة عربية جديدة مطعّمة بمئات الألفاظ المعرّبة والمترجمة. وهكذا فقد كان الوعي وعياً بضرورات التقدم عن طريق الابتعاث وبناء المؤسسات والترجمة في كل الحقول، وبخاصة ما كان منها ذا صلة بالتعليم المدرسي والتعليم في المعاهد العلمية المتخصصة.
لذلك كان مفاجئاً ما بدأ في النصف الثاني من القرن التاسع عشر من حملات على اللغة العربية بالذات من جانب رجالات الدراسات الاستشراقية، ومن جانب الكثيرين من المعنيين بالشأن النهضوي العام من التحديثيين، وقد امتدّت رحلة الاندفاع لمجابهة العربية النيوكلاسيكية إلى مشارف ثلاثينيات القرن العشرين، حين تحوّل الصراع على العربية يومها إلى صراع على الهوية الثقافية للأمة.
تركّزت الهجمات على العربية الفصحى المستعملة في الجرائد والترجمات في ثلاثة محاور: الدعوة إلى العامية، والدعوة إلى استبدال الحروف العربية من أجل التيسير، والدعوة إلى تيسير قواعد النحو والبلاغة والبيان.
ولاشكّ أنّ اقتراحات تفصيلية كثيرة ضمن الخطوط العامّة للأمور المذكورة سابقاً كانت صالحة من أجل النهوض بالعامية، وتمكينها من أداء دورها في التثقيف . لكنّ الطرائق التي جرت بها المقترحات، ومحاولات فرضها: نفّرت عرباً كثيرين مسلمين ومسيحيين منها، وقد انصرفوا جميعاً - وبخاصة الشوام المهاجرون إلى مصر - للردّ على تلك الدعوات.
ربط المسلمون بين هذه الدعوات والتآمر على القرآن ولغته. أما المسيحيون فرأوا ذلك بمنزلة محاولات لإزالة بقايا التمايز بين الإثنيات ضمن الدولة العثمانية، لذلك انصرفوا هم أيضاً لصناعة دوائر المعارف، وافتتاح المجلات الأسبوعية والشهرية، ونشروا قواميس كثيرة تعرّضت لمختلف المشكلات اللغوية.
ويريد بعض الباحثين التفرقة في مسألة الدفاع عن العربية، أو التمييز بين المسيحيين والمسلمين أو أين دوافعهم. فالوعي في بلاد الشام وعي عربي يعتبر اللغة العربية عنصراً أساسياً من مكوّناته. والوعي الديني فيها متميّز من خيط هذا الوعي عند طائفة ومتحد به عند طائفة أخرى. إذ إن المسلمين والمسيحيين في الشام خدموا اللغة على حدّ سواء: بإحياء تراثها، وتأليف معجماتها، واعتبروها رمزاً وطنياً وقومياً لا يرقى إليه النزاع والاختلاف.. أمّا الوعي القومي في مصر فمصريّ خالص، لا ينظر إلى اللغة على أنها جزء من مقوّمات هذه القومية، في حين يحرص الوعي الديني على اللغة حرص الوعي القومي في الشام عليها.
ولستُ على بيّنة من أسباب ظهور هذا الاتجاه المتشدّد تجاه الفصحى، ولدى الأجانب والعرب على حدّ سواء، إذ لا يمكن تعليله بالتآمر على لغة القرآن وحسب، لكن ربما رجع ذلك إلى التمييز بين التقدم والحداثة. فقد اعتبر كثير من الباحثين الأجانب المعنيين بالشئون الشرقية أن عمليات بناء الدولة بالمشرق، المستندة إلى تأكيد المقومات الذاتية (قيم الإسلام الأصيلة)، لا تحقق التحديث. أو أن التقدم بالمعنيين المادي والثقافي لا يفيد في الوصول إليه الاستناد إلى أطروحة التجدد الذاتي. لكن على أي حال، فإن الهجوم على العربية باعتبارها لغة النخبة لا لغة الشعب، وباعتبارها حاملة قيم تاريخ مضى وانقضى، دفع العرب - مسلمين ومسيحيين - إلى التمسك بها، والعمل على تجديدها لتكون صالحة للمرحلة الجديدة. فما عادت اللغة أداة في الترجمات والصحافة والمجلات الجديدة فحسب: بل عبّرت أيضاً عن بدايات إحساس بالذاتية، أظهر نفسه سياسياً في الدعوة إلى خلافة عربية تارة، أو إلى لامركزية عربية ضمن الدولة العثمانية، تارة أخرى.
وبذلك ظهرت البراعم الأولى
لهوية قوامها أمران: اللسان والتاريخ، ضمن الانتماء الإسلامي العثماني
الواسع. وإذا كانت الدوافع الدينية قد لعبت دوراً ما في هذا الشأن في مصر،
فإن مسيحيي الشام لم تكن لديهم دوافع دينية للدفاع عن العربية، بل اندفعوا
من أجل التمايز والذاتية، كما عبّر عن ذلك كل من أديب إسحاق، وفرح أنطون
ورشيد رضا وعبدالحميد الزهراوي، فيما بين مطلع القرن العشرين، ونشوب الحرب
الأولى.
من الذاتي إلى القومي
قامت الدولة الوطنية في فترة ما بين الحربين على أنقاض مشروع الدولة الإصلاحي في حقبة التنظيمات، وفي مواجهة بدأت هادئة مع رجالات التجديد الثقافي العثماني ما لبثت أن تحوّلت إلى صدام في الخمسينيات والستينيات. أيديولوجيا البناء الذاتي، والتجديد العربي الإسلامي، تحوّلت بعد العشرينيات إلى أيديولوجيا للبناء القومي. وكانت تلك البيئة الانقسامية بيئة صراعات بين مشروعات الهوية المختلفة. ظهرت على الساحة بقوة الفكرة العربية، وراحت تبحث عن مرتكزات لها في الوطن والإثنية واللغة والتاريخ. وبسبب الهوية القومية المتوهجة التي نشرتها الدولة الكمالية، فإن التمايز بدأ بين الفكرة العربية الجديدة التي طمحت إلى أن تخلف دار الإسلام وانتماءها، وأن تستوعب طموحات الإثنيات والهويات المحلية من جهة ثانية. واستناداً إلى المثال القومي الوحدوي اتخذت تلك الدولة لنفسها صورة الدولة/الأمة الاندماجية الطابع التي لم تكنها ولم تستطع بلوغها. كانت هناك من جهة عوامل نصرة الفكرة العربية أو أيديولوجيتها والمتمثلة في وهج الأمة الكلاسيكية التي أقامها العرب، وهاهم يتسلمون زمامها من جديد، وكانت هناك من جهة ثانية الإمكانات التحشيدية للفكرة الناجمة عن مقاومة الانتداب والاستعمار، وكانت هناك من جهة ثالثة مقالات الأمة/الدولة الأوربية، التاريخ والممارسة، وكانت هناك من جهة رابعة العقائديات القومية الفاشية التي انتشرت فيما بين الحربين. أما الكوابح فتمثلت في العصبيات والإثنيات المحلية ذات الدعوى الثقافية/السياسية، كما تمثلت في ترتيبات القوى الاستعمارية والنظام الدولي الصاعد. وقد طمح المثال العربي الإسلامي للأمة والدولة إلى استيعاب المحليات والدوليات في الوقت نفسه بتمثل حساسيات كينونتها، وإمكانات انتظامها ضمن النظام الدولي وتجلياته في المنطقة، ومن هنا، فإن تعديدات إدمون رباط والعلايلي والحصري والشهبندر وسواهم لعوامل ومسوغات الظهور القومي للأمة العربية، ما كانت علتها الإصغاء للمثالات القومية الفاشية والستالينية والأتاتوركية وحسب، بل وطموحها أيضاً إلى الاستيعاب والتجاوز. فعروبة العشرينيات والثلاثينيات في الشام والعراق على الخصوص كانت مطمحاً إلى احتواء الجوهر الخالد المصمت لأمة أنطون سعادة السورية، وفينيقيات مسيحيي لبنان، وعصبيات عشائر الشام المتنافرة، لكن ذلك المزيج الثقافي/السياسي، ما وصل إلى حدود الانتظام المأمولة لعدم القدرة على التنسيق بين حركات التحرر، والمركزية القطرية العازلة غير المستوعبة، والحضور الطاغي للقوى الاستعمارية، والسلبية المكتنفة للأجواء والبيئات الثقافية والسياسية المصرية، وبدايات نزعات الخصوصية والطهورية الإسلامية. ومن هنا كان ذلك الذعر الذي أصاب العروبيين والإسلاميين من أطروحة علي عبدالرزاق عن هوية الدولة الوطنية التي تقف إزاء الإسلام وقفة حيادية. ومن أطروحة طه حسين الثقافية التي تقترح انتماء متوسطياً ليس في مواجهة، لكن بالتوازي مع الانتماء العربي الإسلامي المتجه للتبلور في أيديولوجيتي الوحدة والقومية آنذاك.
في عصر الحرب الباردة
العربية والقطبية ما كان اللسان العربي، ولا كانت الثقافة العربية أولوية.
لكن ومع انقضاء السبعينيات، كانت ثقافة عربية واحدة قد تبلورت يحتضنها
اللسان العربي المحدث. أما الهوية العربية بأبعادها الرمزية والسياسية، فقد
كانت ولاتزال تعاني إحباطا وضياعا لا يعودان إلى عدم تحقق المشروع السياسي
وحسب، بل لاحتذاء الدولة القطرية نموذج الدولة/الأمة دون توافر شروطه
أيضاً.
ثقافية لا سياسية
يرى المفكر الألماني فيخته أن الوحدة الثقافية أو تبلور الأمة في الثقافة، يمهّد لتبلورها سياسياً. وهذا خلاف المعروف من تاريخ الدولة القومية الأوربية. إذ تبلورت الأمة داخل الدولة. ونحن نملك اليوم ثقافة عربية واحدة، تقوم على لغة واحدة للكتابة في سائر الموضوعات، وإشكالياتها وأسئلتها متشابهة، ونتاجاتها الإبداعية محط إعجاب جماعي. فالهوية الثقافية العربية متحققة بفضل جهود مئات قليلة من المثقفين. ومع أن الهوية السياسية الواحدة لم تتحقق، فإنني لا أحسب ذلك علة لمأزق الهوية الذي نعانيه، والذي يعبّر عن نفسه بأشكال مختلفة. فنحن نكتب كثيراً في التعريب وندعو إليه، ونحن نخاف الغزو الثقافي ولا نتوقعه فحسب، بل نرى أنه حلّ بنا في ديارنا، ولا ينفض مؤتمر حتى ينعقد آخر حول فخ العولمة وشرورها ونكباتها، ولا حاجة للعودة للوراء كثيراً، فالانفصام الذي حدث بين القوميين البازغين والإسلاميين حول الدولة الوطنية، أحدث لدى الإسلاميين خوفاً على الدين وعلى الهوية. وقد انصرفوا منذ الثلاثينيات لإنشاء جمعيات وهيئات تعنى بالحفاظ على الهوية المبرأة الطهورية من أوضار الغرب، وأوضار القوميين ودولتهم في الوقت نفسه. وبذلك حلت إشكالية الهوية والخصوصية وصونهما محل إشكالية التقدم لدى الإصلاحيين السابقين. واستولدت خصوصيات الهوية سلفية راديكالية تعتمد منهج التأصيل، في تأمل وقائع الداخل والخارج، أي العودة للأصل لقياس المستجدات عليه من أجل شرعنتها أو تحريمها. لكن في الوقت الذي كانوا ينعزلون فيه عن العالم الخارجي ووقائعه ويسيرون باتجاه مواجهته، كان القوميون - خصومهم الذين وصلوا للسلطة في الدولة الوطنية - يعتنقون أيديولوجيا وممارسات الطليعة الثورية التي تقود الناس عقائدياً دون أن تصغي إليهم. وانتهى الأمر إلى صدام بين النخبتين على السلطة وإدارة شئون المجتمع، وليس لأنهم يملكون مشروعات مختلفة للدولة والأمة. وصار الوضع في الثمانينيات أن الدولة ذات المثال القومي استقرت بحسبانها دولة قطرية مغلقة. في حين بلور الإسلاميون مشروعاً مماثلاً للدولة الإسلامية القائمة على الشريعة. وبسبب غيبة الجمهور عن أنظار الطرفين وممارساتهم تصدّعت الأيديولوجيات التي ادّعت دائماً أن الجمهور يقف وراءها، وقد اكتشف الطرفان أواخر الثمانينيات أن خلافهما كان صراعاً على السلطة لا أكثر ولا أقل، وأنهما يعانيان الداء نفسه: العجز عن التواصل مع الجمهور، والخوف من العالم، بل إن العجز عن التواصل مع الجمهور هو سبب خوفهما من العالم، وحديثهما عن الغزو الثقافي. فهناك مشروع ثقافي عربي، أسس لانتماء ثقافي عربي واسع بمعزل عن سياسات الدولة والإسلاميين، لكن ليس هناك مشروع سياسي. المشروع الثقافي صنعته النخب الثقافية دونما مساعدة من الدولة الوطنية أو في مواجهتها، أما المشروع السياسي، فتصنعه النخب السياسية المتواصلة مع الجمهور أو التي أوصلها الجمهور إلى سدّة السلطة، والأمران غائبان، فالخلاف بين السياسة والثقافة في الوطن العربي ليس سببه عدم تحقق الوحدة العربية، بل عدم ديمقراطية النخب الإسلامية والقومية في السلطة وخارجها. ولن يحدث الاتساق بين الانتماء الثقافي العربي - الذي يتحقق باستمرار - من جهة، والمشروع السياسي من جهة اخرى إلا إذا أعاد الناس صياغة هذا المشروع كما صنعوا الهوية الثقافية العربية المعاصرة.
ولم يكن التأكيد على اللغة أو اللسان لدى القوميين والإسلاميين في السنوات الأربعين الماضية مساعداً في دعم اللسان العربي بتحديثه وتطويره وفتحه على آفاق العصر والمستقبل. فقد حالت النزعة العقائدية التي سادت بشأن الهوية ومكوّناتها دون قبول ما اعتبره القوميون والإسلاميون على حد سواء تنازلات في مسألة الثقافة، تؤدي إلى تنازلات في قضية الهوية. لقد رأى زكي الأرسوزي - مثلاً - أن العبقرية اللسانية العربية هي جوهر العبقرية العربية ذاتها باعتبار اللسان حاملاً لكل مكوّنات الهوية، وفضلاً عن النزعة الجوهرية السكونية لهذا الاعتقاد، فإنه لم يربطه بأي نقطة أو مساحة تاريخية، مثل القرآن أو أدب العصر العباسي أو معاجم اللغة، فجاء في استناده إلى الجاهلية وشعرائها - باعتباره ذلك العصر عصر البراءة والإبداع، غير تاريخي أيضاً، فالقوميون قدموا الهوية العربية باعتبارها نموذجاً مصمتاً كاملاً، اكتمل في الثقافة منذ آماد وآماد، واستحدثوا هم (الطليعة الثورية) وعياً بضرورة اكتماله في السياسة بقيام الدولة العربية الواحدة بقيادتهم. أما الإسلاميون فقد تدرّجوا في مغادرتهم ثم في مواجهتهم للمشروع أو الرؤية القومية للهوية. قال حسن البنا بقيام الهوية العربية الإسلامية على اللسان والتاريخ، ثم لما اصطدم القوميون الواصلون للسلطة في الدولة القطرية بالإسلاميين، سارع أولئك إلى رفض القومية العربية باعتبارها استيراداً غربياً، يريد الحلول محل الهوية الإسلامية. وإذا كان القوميون عقائديين، فإن الإسلاميين كانوا ولايزالون الأكثر إصراراً على جوهرية الهوية، ولا تاريخيتها، لذلك كان من المنطقي أيضاً أن يرفض الإسلاميون كل مقترح للتطوير اللغوي باعتباره تآمراً على لغة القرآن، وعلى الميراث الديني العربي الإسلامي.
ومن هنا، كان ذهابي إلى أن الثقافة العربية المعاصرة، استطاعت أن تكون كذلك لتكوّنها وتطوّرها خارج أحضان الفريقين، ذلك أن المبدع لا يستطيع أن يكون حزبياً خالصاً. ثم إن الواضح أن المشكلة أو الإشكالية لا تنشأ عادة في الثقافة، فالثقافة معطى وانتماء، ويتغير ببطء وعبر آماد متطاولة. والتباسيته، أي التباسية المعطى أو المعطيات الثقافية ،تعبّر عن المساحات الواسعة والمتشعبة والمعقّدة للانتماء الشعبي الذي يتضمن مواريث وأعرافاً ومصالح وتقاليد ومتغيرات. أما الإشكاليات والقرارات، فتحدث في الوعي ومن جرائه، والوعي القومي والآخر الإسلامي هو الذي واجه ويواجه متغيّرات العرب والعالم ويسارع إلى اتخاذ القرارات بشأنها.
ولا أستطيع أن أنحي فكرة أزعجتني طوال أسابيع كتابتي لهذه الورقة، لقد خالجني شعور غلاب بأن القوميين العقائديين والإسلاميين العقائديين أو الأصوليين، كلا الطرفين لم يكونا يخشيان على اللسان العربي من التحديث والعصرنة والشعوبية وحسب، بل كانا يخشيان أيضاً من اللسان العربي على مشروعهم أو مشاريعهم أيضاً، فاللغة العربية كائن تاريخي تغيب جذوره في الماضي، ويحمل في أحشائه أوابد ومواريث وأعرافاً وبقايا ثقافات، ثم إنه تحضر فيه - وإن بدرجات متفاوتة - الشفويات والعامّيات وآداب سائر الفئات الاجتماعية ومصالحها وأشواقها وآمالها. هذا الكائن الحي شديد الحيوية والمرونة، ويستعصي على القبض والضبط والإمساك.
ومن هنا، فإن العقائديين العرب - قوميين وإسلاميين - يضعونه في خانات المقدس، ليهدأ وينضبط فلا يزعجهم بتغيراته ولا عقائديته. ويمكن أن أذكر شاهداً على ما أعنيه تلك الثنائيات التي شاعت ولاتزال دون أن تصل إلى مستقر منذ أواخر الستينيات. أشهر تلك الثنائيات ثنائية العروبة والإسلام، أثارها أولاً القوميون المتحوّلون إلى يساريين بحجة علمنة العروبة، وإخراج العناصر الميتافيزيقية منها والتي تسببت في هزيمة العام 1967 بزعمهم، وببقاء البورجوازيات العربية الصغيرة في السلطة، وقد قال لي أحدهم إن اللغة العربية ينبغي أن يسقط منها من الألفاظ والتعبيرات مالا يقل عن خمسين بالمائة من استعمالاتها المعاصرة لتصبح علمانية خالصة تقدمية، كما فعل مصطفى كمال في اللغة التركية! ولم ينزعج الإسلاميون وقتها من ذلك، بل قالوا إن الفصل ضروري لأن العروبة القومية - وليس عروبة اللسان - هي ضد الإسلام، وقد اقترح كل من أحمد عبدالغفور عطار وأنور الجندي سبلا لكيفية إزالة المواريث والبدع القومية من عربية الإسلام والقرآن.
وبعد، هل يستطيع البطريق الرومي الذي يتقن العربية، ويريد العيش في أرض العرب، أن يكون عربياً? ألا يكون منطقياً أن نجيب بنعم، وبخاصة إذا لاحظنا أن العربي يهاجر إلى أمريكا فيصبح أمريكياً في أقل من جيل واحد. ثم يعود إلينا أبناؤه وأحفاده بانتماء عربي متشدد دون أن يعرفوا كلمة عربية واحدة!
هناك الهوية، وهناك
الانتماء، وفي الحالات العادية فإن الانتماء نسق عام، والهويات أنساق فرعية
على النسق العام أو ضمنه. وقد مرّت علينا عقود غاب فيها النسق العام ليس من
الثقافة بل من الوعي. فالمشكلة ليست في الانتماء المستند إلى الثقافة، بل
في الوعي المستند إلى الهوية، والثقافة لا تتجدد من داخلها، كما أن الوعي
لا يتجدد من داخل الثقافة، فبداية التصدي لمشكلاتنا اللسانية والثقافية
والسياسية ينبغي أن تلتمس في تصحيح علائقنا بعالم العصر وعصر العالم. في
مرحلتنا القومية أردنا الانفصال عن العالم فظهرت القطريات السياسية
والثقافية المتشددة، وفي مرحلة الصحوة الإسلامية، أردنا الانفصال أيضاً،
فصار شبابنا عرباً أفغاناً أو عرباً ألباناً أو عرباً بوسنيين. أما العرب
المسلمون الذين يريدون العودة لأنفسهم ولأمتهم، فالطريق إليهم يكون
بالانخراط في العالم، ومحاولة الحركة فيه بفعالية عن طريق المشاركة القوية
والمبدعة، وأحسب أنه عندها لن يكون هناك تناقض بين الهوية والانتماء، ولن
يكون هناك خوف من الغزو الثقافي أو، وهذا هو الأرجح، فإن الإشكاليات
ستتغير، فتكون مشكلات في طريق النجاح، وليس عوائق متتابعة في عقبات مجهولة
الموارد والمصادر.
عودة إلى قائمة الخطاب الفلسفي - سؤال الهوية