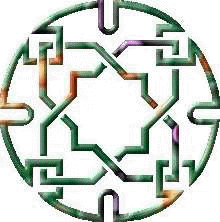
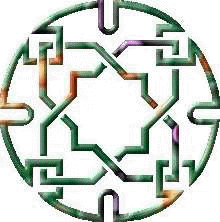


الكونية هل هي تهديد للهوية الأضعف؟

يوسف الشاروني
مجلة العربي
1 أكتوبر 2002
ماذا تفعل الجماعات المختلفة عندما تجد تهديداً مباشراً لموروثاتها وتقاليدها؟ هل تتخلى عنها؟ أم تزداد تمسكاً بها؟
يرى البعض أن العولمة بديل للاستعمار, باعتبار أنها في النهاية تكريس لهيمنة الدول الأكثر تقدماً على الدول النامية, أو سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصادات الوطنية والمحلية لهذه الدول, لكن من خلال أدوات تختلف عن أدوات الحرب الباردة, بمعنى آخر فإن أهداف الاستعمار كانت السيطرة على الشعوب للاستفادة من إمكاناتها الاستراتيجية عن طريق قوة السلاح, بينما مفهوم العولمة يهدف أيضاً إلى السيطرة على الشعوب لكن من خلال توجيهها لاتباع نمط تنموي يخدم أساساً مصالح الدول المتقدمة, وقد يحقق قدراً من التنمية للدول النامية, لكن مخاوف هذه الدول الأخيرة من سلبيات العولمة عبّرت عنها تلك الاحتجاجات والتظاهرات التي اندلعت ضد قمة الدول الصناعية الكبرى في اجتماعاتها الثلاثة الأخيرة في سياتل بأمريكا عام 1999, ثم في براغ بجمهورية التشيك عام 2000, حتى بلغت ذروتها في اجتماعها بجنوة بإيطاليا العام الماضي (يوليو 2001) حيث وقع أول صريع ضد العولمة هو الشاب (كارلوجيلياني) مما دفع بالأمن الإيطالي إلى وضع الزعماء خلال اجتماعاتهم داخل قفص مغلق من التحصينات والحواجز التي فصلت منطقة وسط مدينة جنوة عن بقية أحياء المدينة وأطلقوا عليها اسم (المنطقة الحمراء) لضمان أمن الرؤساء وسلامتهم خلال ثلاثة أيام الانعقاد.
إن ما دفع هؤلاء المتظاهرين إلى احتجاجهم هو إحساس بعدم مصداقية الدول الكبرى في التصدي الجاد لمشكلات السلام والفقر والبيئة في العالم. لقد تظاهر أكثر من 200.000 يمثلون 1170 جماعة ونقابة ومنظمة غير حكومية, كما اندلعت تظاهرات التنديد بالعنف المفرط المستخدم ضد معارضي العولمة في دول مثل تركيا وبريطانيا وألمانيا, بل إن أحد السحرة في إيطاليا استدعى الأرواح الطيبة للتأثير في قادة هذه الدول الثماني الكبرى لاتخاذ قرارات إيجابية, ذلك لأن قادة هذه الدول لم يتركوا أي بصيص للآخرين يرون فيه أملاً في إمكان التراجع عن مغريات التجارة الحرة ومشاريع الشركات المتعددة الجنسيات التي تراكم من ثروات الأغنياء على حساب المصالح المحدودة والبسيطة للفقراء, مما يتسبب في زيادة الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة, ويؤدي إلى تعميق مشاعر اليأس والإحباط التي يترتب عليها ما هو أوسع وأعمق من مجرد الاحتجاجات والتظاهرات.
ولقد ناشد البابا يوحنا بولس الثاني زعماء قمة جنوه ضرورة التخلي عن أنانيات التجارة وما وصفه بمبادئها المتوحشة, مما أثار في ذهن الجماهير رفض الولايات المتحدة الأمريكية التصديق على معاهدة كيوتو من أجل حماية البيئة لأنها لا تريد المساس بمعدل النمو الأمريكي, وإصرارها على مشاريع لا تلقى حماساً من حلفائها المقرّبين مثل عسكرة الفضاء والدرع الصاروخية لأنها تحمّلهم عبئاً اقتصادياً لا مبرر له ضد عدو مجهول.
وهكذا نواجه عالماً زاخراً بالمتناقضات تتوازى فيه تكتلات دولية مع تفتيت دويلاته, كما حدث في يوغسلافيا السابقة وفي إندونيسيا, وهم يحومون حالياً حول شمال العراق وجنوب السودان, مما دفع أحد الخبراء المصريين إلى التساؤل: هل نحن في طريقنا إلى عالم الألفي بلد كما يتوقع البعض؟ (نبيل علي, الثقافة العربية وعصر المعلومات, عالم المعرفة, ص 30), ومن تناقضات عالمنا المعاصر أن نموّه الاقتصادي في جانب الأثرياء يتسابق مع عدد فقرائه في جانب آخر, وكأن لا تناقض بين الحديث عن السلام, والمائة والخمسين حرباً التي نشأت منذ الحرب العالمية الثانية, حيث يرى البعض أن نجاح العولمة هو الشيء الوحيد الأكثر سوءاً من فشلها (المرجع السابق, ص 12-13).
العولمة ونقيضها
فالعولمة تخلق نقيضها, كما سبق أن خلق النظام الرأسمالي نقيضه الشيوعي, ذلك لأن العولمة - شأنها شأن أي تقدم حضاري - سلاح ذو حدين مادام يوجهها بشر, تماماً مثل الطائرة التي يمكن استخدامها لنقل البضائع والبشر, ويمكن استخدامها لإلقاء القنابل والرعب والدمار. فالثقافة الكونية نظرياً لا حدود لأصدائها الإيجابية التي تدفع إلى معرفة الآخر مما يترتب عليه منطقياً انتشار ثقافة التسامح وتواري ظاهرة التعصب, كما أن من شأنها كسر احتكار الدولة للمعلومات - على عكس ما تنبأ به جورج أورويل (1903-1950) في روايته (1984) التي كتبها عام 1949 - واختراق الحدود القومية, وتوحيد أنماط الاستهلاك والعمل وإدارة الاقتصاد الوطني, بل ووسائل كسب العيش.
هذه الإيجابيات نفسها هي التي خلقت سلبياتها, فالثقافة الكونية بهذا المعنى أصبحت تمثل تهديداً لأساليب الحياة التي طالما تبنتها الجماعات المختلفة للتعبير عن هويتها, مما يدفعها إلى التمسك بالموروث والاحتماء به في مواجهة ما تواجهه من ضغوط مستجدة - فضلاً عن أن هذه الثقافة الكونية جعلت الدول الغنية والفقيرة تعي مدى الفجوة بينهما, بل إن العولمة التي نشرت هذه الثقافة بشكل غير مسبوق هي التي ضاعفت من غنى الأغنياء وفقر الفقراء. ومما ساعد على تفاقم الفجوة مسارعة ما يسمى بدول المركز بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاستفادة بميزات العولمة لصالحها أولاً على حساب شعوب ما يسمى بالدول الأطراف مما خلق ردود فعل متباينة لدى هذه الشعوب ساعدت العولمة نفسها على تحقيقها مثل هجرة الكفاءات السكانية من الدول الفقيرة إلى الدول الأغنى لتتكامل سوق العمل الدولية وتؤدي إلى زيادة غنى الدول الغنية وفقر الدول الفقيرة. ولقد كانت تجارة العبيد شكلاً من أشكال الهجرة غير الإرادية فيما نطلق عليه التهجير, ثم اتسعت ظاهرة الهجرة الاختيارية بعد الحرب العالمية الثانية إلى أوربا أولا لملء الفراغ الذي أحدثته الحرب في القوى العاملة التي قامت بإعادة إعمار ما دمّرته الحرب, ثم إلى بلاد الهجرة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا, لكن هذه الهجرات لم تحل مشكلة الانفجار السكاني في الدول الفقيرة - وإن خفضت منها مرحلياً أو أجلتها - ذلك لأن سكان هذه الدول يستفيدون بالتقدم الطبي في خفض الوفيات ولا يستخدمونه في خفض مواليدهم, وتكون النتيجة كبح النمو الاقتصادي لهذه الدول بسبب تزايد عدد المسنين المتدهورين صحياً وغير المنتجين اقتصادياً, وتوجيه نسبة من الموارد لإعالتهم والعناية بهم, وعلى الجانب الاخر, فإن تسارع نسبة المواليد تؤدي إلى أن تكون أغلبية السكان تحت سن العشرين مما يعني استهلاكاً ضخماً في الموارد للإنفاق على إعالة وتعليم أطفال غير منتجين اقتصادياً أيضاً, فإن عجز النمو الاقتصادي والاستثمار في الوظائف الجديدة عن ملاحقة النمو السكاني, يجعل هذه المجتمعات تواجه تهديداً أكثر مباشرة وثورة من شبح المجاعة عند مالتوس (Malthus, 1766-1834) هو الجماهير الغفيرة من العاطلين الشباب كلياً أو جزئياً دون أن يكون لهم أمل في المستقبل يحقق لهم أدنى طموحاتهم, مما يجعلهم أرضاً خصبة للتجنيد من الجماعات السياسية الساخطة والمتمرّدة (المرجع السابق, ص 156).
العولمة والهوية الذاتية
مفارقة أخرى من مفارقات الثقافة الكونية تؤدي إلى النتيجة السابقة نفسها, فبحكم طبيعة المجتمعات والثقافات المهيمنة على النظام الدولي, فإن ثقافتنا الكونية المعاصرة ليست متحررة من الأيديولوجيا والقيم الثقافية والسياسية وفي مقدمتها ما يُعرف بالليبرالية بكل ما تتضمنه وتؤكده من قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية الثقافية والمساواة بين الثقافات, هذه القيم والمبادئ هي الأكثر انتشاراً ونفوذاً في النظام الدولي الحالي, وهي قيم ومبادئ تشجع الجماعات المختلفة في الدول الفقيرة عرقية ودينية ولغوية على تأكيد هوياتها الذاتية والتعبير عنها بوضوح, بل أحياناً بالعنف, كلما استشعرت هذه الجماعات أن هذه الدعوات والمبادئ تقف عند حدودهم ولا ينالون منها نصيباً بسبب الهيمنة الأحادية التي تنادي بالليبرالية والمساواة ثم توزع بركاتها ولعناتها طبقاً لمصالحها.
كذلك فإن تكنولوجيا المعلومات ستؤدي إلى ظهور نوعيات جديدة من الوظائف غير تلك التي أفرزتها التكنولوجيا الصناعية, وفي الوقت نفسه ستمحو من الوجود كثيراً من الوظائف والأعمال التقليدية, مما يترتب عليه نقص فرص العمل حتى ليكاد يصبح العمل نوعاً من الرفاهية التي تستأثر بها قلة, وبالتالي يتضاعف عدد الفقراء الذين يصبحون وقوداً جيداً في أي صراعات تطلعا إلى احتمالات الحصول على وضع أفضل (المرجع السابق, ص 89).
كذلك فإن المؤسسات الثقافية تسعى في عصر الثقافة الكونية إلى إضفاء الطابع التجاري على الإنتاج الثقافي والإبداعي, مما يؤدي إلى إعادة تشكيلها في القالب النمطي الجديد للتصنيع والتنظيم الاقتصادي, والذي يكون المكسب والخسارة هما الأساس الأول - إن لم يكن الوحيد - لتحديد قيمة الإنتاج الثقافي والإبداعي, لا تعنيه القيم الأدبية أو المؤجل عائدها, ولا الخسائر الاجتماعية طويلة الأجل, وقيم المكسب والخسارة لا تصلح للإبقاء على تماسك الجماعة, بل لعلها تضاعف من حدة المنافسة بين أفرادها وهيئاتها, بينما تتوارى قيم مثل الكرم والتضحية لأنها لا تتضمن أي مكاسب عاجلة منظورة, إن لم يبد أنها تتضمن خسارة آنية في المال أو النفس, وما أيسر اشتعال النار في الجماعات المفككة سواء بين أفرادها أو طوائفها, أو بينها وبين جيرانها إذا وجدت من يتزعمها ليوجّه طاقاتها نحو الآخر بدلاً من توجيهها نحو النفس.
ولا نبرئ تجار السلاح من دورهم في تغذية عوامل الفرقة ونفي الآخر بين الطوائف والدول, بعد أن أصبح احتمال نشوب حرب عالمية أمراً متعذراً إن لم يكن مستحيلاً بعد عولمة السلاح النووي والصواريخ عابرة القارات. فكما جاء في تقرير الكونجرس الأمريكي أنه في عام 2000 بلغت قيمة مبيعات الأسلحة الدولية 36.9 مليار دولار, وجاء على رأس المصدرين الولايات المتحدة الأمريكية تليها روسيا وفرنسا, أما أكثر المشترين فهي الدول النامية - أي الفقيرة - وفي مقدمتها دول الشرق الأوسط.
ضعف قبضة الدولة
سبب آخر من أسباب الصراعات الناتجة عن العولمة هو ضعف قبضة الدولة كسلطة على الصراعات الناشئة عن التعددية المتنامية في المجتمعات الحديثة, فمن بين سمات الدولة الحديثة امتلاك واحتكار وسائل العنف داخل أراض محددة, ويرى البعض أن الدولة بهذا المعنى مرحلة تاريخية بسبب تكنولوجيا الاتصال والمعلومات التي تعمل على التخفيف من استئثار الدولة بالسيطرة على حدودها, وما يترتب على ذلك من إنقاص قدراتها على السيطرة الثقافية وفرض التجانس. فالاتصالات الرقمية والأقمار الصناعية وآلات الفاكس وشبكات الكمبيوتر والمعلومات جعلت من المستحيل على الدولة السيطرة على الإعلام وتدفق المعلومات, كما وضعت حداً لقانون السرية الذي كانت الدولة تحتمي به, وبذلك فإن الثقافة الكونية لا تهدم الدكتاتوريات الأيديولوجية فحسب, بل كل محاولات الحفاظ على التجانس الثقافي بواسطة سلطة الدولة (المرجع السابق, ص 264). وهكذا فإنه في ظل عولمة الاقتصاد والشركات المتعددة الجنسيات تتجه سلطة الدولة لتصبح مجرد سلطة محلية للنظام الدولي لأنها لم تعد تستطيع أن تؤثر مستقلة في مستويات النشاط الاقتصادي أو العمالة داخل حدود أراضيها حيث إن هذه المستويات تمليها اختيارات رءوس أموال حرة الحركة عالمياً. ويشبه البعض مصير الدولة القومية بوظيفة المجالس البلدية والمحلية, أي تقديم البنية التحية والخدمات العامة التي تحتاج إليها الأعمال الاقتصادية بأقل تكلفة ممكنة (المرجع السابق, ص 257). وبمعنى آخر فقد أصبح على الدول الأقل تقدما أن تقبل مستوى غير مسبوق من التدخل في شئونها الداخلية دون ضرورة اللجوء إلى التهديد بالسلاح العسكري (وإن كان هذا السلاح ماثلاً كرأس الذئب الطائر في كليلة ودمنة, وآخر أمثلة على ذلك ضرب العراق أو ضرب صربيا).
كذلك فإن الثقافة الكونية فتحت أعين الفقراء على أنماط استهلاكية فوق طاقتهم وقدرتهم حين يشاهدون على شاشات التلفزيون وعبر الفضائيات - سواء في المسلسلات أو الإعلانات - جنوناً استهلاكياً وترفياً غير مسبوق مصحوباً بدعاية تثير الأحلام والأحقاد حين يشعر الفقراء بعدم قدرتهم على مجاراة هذا الجنون الاستهلاكي فتتولد في نفوسهم كراهية الرأسمالية المتوحشة وكل ما يمت لها بأي صلة. وندرك خطورة هذا الشحن الانفعالي عندما نكرر أن العولمة أدت إلى اتساع غير مسبوق في التاريخ للفجوة بين الأغنياء والفقراء سواء على مستوى الدول أو على مستوى المجتمع الواحد وبطريقة متسارعة, مما يعد وقوداً لأي صراعات كما هو حادث - على سبيل المثال - في وسط القارة الأفريقية بين قبائل الهوتو والتوتسي, والتي تمتد صراعاتها بين ثلاث دول: زائير وبوروندي ورواندا.
تفتت العالم
صحيح أن هناك وحدات كانت قد تفككت في القرن العشرين ثم عادت فتوحدت كما حدث بين شطري كل من ألمانيا وفيتنام واليمن, بالإضافة إلى تنجانيقا وزنجبار اللتين أصبحتا تنزانيا, وخطوات الوحدة الأوربية, لكن في المقابل نجد أن الأمم المتحدة حين أنشئت عام 1945 لم يكن بها سوى احدى وخمسين دولة أصبحت اليوم 184 دولة, بعضها دول لا يزيد حجمها على حجم جزيرة يقطنها بضعة آلاف من السكان, ولا يستطيع ممثلها في الأمم المتحدة أن يمتلك سيارة يذهب بها إلى مقرها, فيذهب إلى اجتماعاتها سيراً على القدمين, ويقال إنه ليس من المستبعد أن يتضاعف العدد بعد عشرين عاماً. صحيح أن هناك دولاً كثيرة من بين تلك التي انضمت إلى الأمم المتحدة كانت موجودة قبل انضمامها إلا أنه صحيح أيضاً أن دولاً أخرى برزت من العدم أو من انقسام سلمي لإحدى الدول - وهي حالة نادرة - كما حدث مع تشيكوسلوفاكيا التي أصبحت دولتي (التشيك) و (سلوفاكيا) أو نتيجة حرب كما حدث مع دولتي بوسنيا والكروات اللتين انضمتا إلى الأمم المتحدة عام 1992. فضلاً عن تشظي الاتحاد السوفييتي إلى أكثر من عشر جمهوريات يحارب بعضها البعض كما حدث بين أرمينيا وأذربيجان. وكما يحدث الآن في الشيشان وبين مقدونيا والألبان. ويتساءل كل من تابع من أنباء السياسة العالمية: هل حدث استنساخ لهابيل وقابيل في كشمير وسيريلانكا والجزر الأندونيسية وفي نيجيريا والسودان ولبنان, لا يحول دون ذلك حتى انتماء القوم إلى عقيدة واحدة حيث يمكن أن تتشظى إلى انتماءات أضأل كما يحدث في إقليم الباسك الإسباني وأيرلندا الشمالية وأفغانستان والجزائر والصومال والقبائل الإفريقية, كأن هناك مَن يمسك بجهاز (ريموت كنترول) ليسيطر على العالم بهذه الوسيلة كما حدث مع الشام والخليج العربي سابقاً والقارة الهندية التي أصبحت أربع دول بعد أن كانت دولة واحدة, ثم الاتحاد السوفييتي أخيراً.
وإذا كانت هذه هي الرؤية من خلال منظار مقرّب, فإننا إذا نظرنا من خلال منظار مكبّر نجد أن من أبرز عوامل التفتيت في منطقتنا العربية إنشاء دولة إسرائيل على أساس عقائدي عنصري, فكان رد الفعل الطبيعي دفاعاً عن الوجود المهدد هو التحصين في الهوية العقائدية المقابلة, بكل ما حمل ذلك من تيارات إيجابية وأخرى سلبية اتجهت إلى تدمير الذات أمام عجزها عن تدمير مصدر التهديد, فضلاً عمّا يتردد من قصور في مناهجنا التربوية والإعلامية والدينية والتنموية, وفي أداء بعض أجهزتها التنفيذية والشعبية, وإن كان البعض يرى أن هذا القصور إفراز من إفرازات هذا المناخ العام نحو التشرذم أكثر مما هو سبب له.
الريف والمدينة
ومن جانب آخر يرى الدكتور الكسندر إيفانوف الباحث في العلاقات الدولية بموسكو في مقاله المنشور بمجلة الحرس الوطني السعودية بعنوان (العالم الإسلامي والنظام العالمي الجديد - وجهة نظر روسية - أبريل 1997, ص 34-38) أن منطقة الشرق الأوسط ببعدها العربي الاسلامي تدفع أفدح ضريبة تاريخية حين تحولت إلى ما يشبه الريف المحيط بالمدينة, أما المدينة فهي الولايات المتحدة الأمريكية التي يمدها الريف العربي الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط بالمواد الخام وسواعده الكادحة ولا يتلقى بديلاً إلا ما يقيم أوده. المدينة تأخذ من الريف ما هي في حاجة إليه وما هي ليست في حاجة إليه, والريف يقتنع بما تجود به عليه المدينة سواء سد حاجته أم لا, ثم يصوّر الباحث الوعي الجديد الذي بدأ يشيع بين أبناء الشعوب العربية نتيجة الإحباط وخيبة الأمل مما يدفعهم إلى البحث عن الهوية وعن مكان خاص بهم في التاريخ, ومستخلصاً أن النظام العالمي الجديد إن لم يتق مخاطر انفجار الفقر والظلم فإنه سينتهي إلى اللانظام, أي إلى الفوضى التي تأتي على مَن أشعلوها ومن دبّرت لهم. (النص منقول عن: د. عبدالسلام المسدي, العولمة والعولمة المضادة, كتاب سطور, القاهرة 1999, ص 146). وقد نبه أكثر من مفكر أجنبي مثل جارودي وعربي مثل عبدالله الحسن في كتابه (الأقليات في الواقع العربي: الاندماج والتجزئة) إلى ما يدبر من تفتيت للكيانات العربية إلى فسيفساء أو جزيئات قومية تتحول إلى مجموعة دويلات طائفية أو عرقية أو لغوية.
سبب آخر يذكره هنتنغتون يشعل وقود الصراعات, ذلك أن كل المستعمرات الغربية السابقة, والدول المستقلة مثل الصين واليابان, كان جيلها الأول للتحديث أو ما بعد الاستقلال يتلقى تعليمه غالباً في الجامعات الأجنبية الغربية, وبلغة غربية كوزوموبوليتانية, ولأنهم كانوا غالباً ما يذهبون إلى الخارج وهم في مقتبل العمر يكونون أكثر قابلية للتأثر, واستيعابهم للقيم الغربية وأساليب الحياة عميقاً. الجيل الثاني, الأكبر حجماً, على العكس من الجيل الأول تلقى تعليمه في الداخل, في جامعات أنشأها الجيل السابق, حيث يتم استخدام اللغة المحلية في التعليم بتوسع أكثر من لغة المستعمر, وتوفير الحد الأدنى من الاحتكاك بالثقافة العالمية, ويكون تأصيل المعارف عن طريق الترجمة, وعادة على مستوى محدود وهزيل. خريجو هذه الجامعات يستهجنون سيطرة الجيل السابق - الذي تدرب في الغرب - عليهم, ومن هنا فإنهم غالباً ما يستجيبون لنداء حركات المقاومة المحلية. (صدام الحضارات, ص 153).
كذلك فإن النمو السكاني في منطقة الشرق الأوسط سيكون قوة تؤدي إلى عدم الاستقرار داخل المجتمعات الإسلامية وجيرانها. فالعدد الفقير من الشباب الحاصلين على التعليم الثانوي سوف يواصلون دعم المعارضة المتمثلة في الصحوة الاسلامية, وتنبأ هنتنغتون بأن السنوات الأولى من القرن الواحد والعشرين من المرجح أن تشهد صحوة متميزة في القوة والثـــقافة غير الغربـــية, وفي الصـــراع بين شـعوب الحضارات غـــير الغربـــية والحضـــارات الغربــــية, وبين بعضـــها البعـــض الآخــــر. (المرجع الســـابق, ص 199-200).
كما يرى أن قمع حكومات الشرق الأوسط للمعارضة العلمانية دعمت من قدرة الجماعات المتأسلمة على السيطرة على المعارضة. (المرجع السابق, ص 188).
وأخيراً يرى البعض أن الطبيعة البشرية من أقوى أسباب الصراعات الإقليمية والعالمية, وأن تاريخ الأمم هو تاريخ حروبها, وأن من طبيعة الأمور - من ناحية - أن يهيمن الأقوى على الأضعف ويستغله لصالحه, ومن ناحية أخرى فإن الصراع حتى بين الإخوة مغروس في الجينات البشرية, فقصة مثل قصة الأخوين قابيل وهابيل Cain And Abel - حين لم يكن على الأرض غير أسرتهما - إنما ترمز لوجود جين العنف في الإنسان. ويرون أن الصراع سيبقى ما بقيت البشرية, فلا أمل في التخلص من الاستعلاء العنصري أو التعصب العقائدي, وهما دافعان يبرزان في مقدمة دوافع الصراعات الطائفية والإقليمية, وربما دول الشمال مع دول الجنوب, بل دول قارة مثل أوربا كما حدث في الحربين العالميتين في القرن الماضي. لكن من المعروف أيضاً أنه كما يمكن إيقاظ الأحقاد إلى حد سفك الدماء بين الإخوة حيث تكون هناك تفرقة في المعاملة بينهم على نحو ما حدث في القصة الدينية: قصة يعقوب ويوسف وإخوته, وفي قصة قابيل وهابيل من قبل فإنه يمكن وأد هذه الأحقاد حين تكون المساواة أساس المعاملة. كذلك الأمر بين الشعوب, يمكن بآليات محددة إثارة الفتن بين مختلف طوائفها أو مع جيرانها (وهو ما حدث في التاريخ نتيجة مؤامرات داخلية أو خارجية) ويمكن تغليب ثقافة احترام الاختلاف, وتغليب العوامل التي تجمع على تلك التي تفرّق بدءاً من التعليم والمنابر العقائدية حتى وسائل الإعلام والقنوات الفضائية. فالخير أيضاً - مثل الشر - نزعة متأصلة في الإنسان.
كيف نواجه الثقافة الكونية؟
لهذا نرى أنه لا سبيل إلى مواجهة ما تتضمنه الثقافة الكونية من جوانب سلبية تتحدى بها منطقتنا العربية إلا بتحقيق عدة شروط منها:
- القضاء على أمية العالم العربي, فالهيمنة على شعب متعلم أصعب بكثير من السيطرة على شعب أمي. ثم إن محو الأمية هو القاعدة الأولية الأساسية لخلق مجتمع أقدر على التصدي.
- ثم ثورة على نظامنا التعليمي, فلا خير في أمة يقوم نظامها التعليمي على تضافر التلقين وقهر الطفل محواً لشخصيته, ولا خير في نظام تعليمي مهمته تخريج متعلمين أميين.
- تطوير تدريس لغتنا القومية, اللغة العربية, بتيسير النحو أولاً, ثم حل مشكلة الشكل حتى يصبح جزءاً من الكلمة وليس منفصلاً عنها - كما هو الوضع الآن - يمكن إثباته ويمكن حذفه.
- ونظراً لأن القرن الحادي والعشرين سيشهد ثورات علمية على نحو لم يسبق له مثيل, وأن البقاء سيكون للأعلم والأقدر, فلابد من تحقيق الشروط العلمية للعلم أولاً, أي وجود المجتمع العلمي بركائزه الثلاث: العلم والتكنولوجيا والمجتمع, التي تشكل معاً مثلثاً متساوي الأضلاع, فالمجتمع العلمي - وأنا أقتبس كلمات د. زويل - يهيئ السبيل للإبداع العلمي ويستقبل نتائجه مهيئاً السبيل مرة أخرى لتطبيقاته. وعلى قدر تشرّب المجتمع بالثقافة العلمية تكون إبداعات العلم والتكنولوجيا وتطبيقاتها.
- ثم هناك مشكلتنا الإدارية التي تعاني من الفجوة - وربما الهوّة - بين التقنين والتنفيذ, بين التنظير والتطبيق, بين الرأس والجسد. وما لم تتلاحم هذه الثنائيات فستظل الفجوة - وربما الهوّة - تزداد اتساعاً بيننا وبين الآخر, فما تفوق الغرب علينا بسلاحه إلا بتفوقه علينا بنظمه الإدارية.
- مزيد من جرعات الديمقراطية لحكوماتنا, بل وأحزابنا العربية, حتى لا تظل الديمقراطية مجرد واجهة بل تصبح ممارسة فعلية, فوجود حكومات عربية هشّة من أبرز العوامل سلبية في معركة التحدي, لأنها تعتمد في بقائها على عوامل ليس من بينها شعبيتها.
- تحقيق - ولو بقدر - وحدتنا العربية المفتقدة, ولتكن بدايتنا تكاملنا الاقتصادي, وهو اتجاه ليس غريباً عن روح العصر, فكثير من دول العالم حولنا تتجه نحو التكتلات الإقليمية وأقربها مثالاً الوحدة الأوربية, ولن يتم هذا التكامل الاقتصادي إلا باستثمار الأموال العربية في البلاد العربية.
- معالجة الترهل السكاني الذي يبتلع كل عائدات التنمية, فالكثرة هنا ليست قوة لكنها سمنة مرضية يجب التخلص منها لأنها تشل حركتنا بل تردنا إلى الوراء.
- تقريب المسافة - وأحياناً الهوّة - بين العبادة والتجارة, فالقول المأثور (اعمل لآخرتك كأنك تموت غداً, واعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً), المقصود به التكامل بين المسجد والسوق وليس إطلاقاً التناقض بينهما.
- وأخيراً ضرورة القضاء على الفجوة المعروفة بين أقوالنا وأفعالنا.
وتبقى مشكلة العبور من التنفيس إلى التنفيذ
عودة إلى قائمة الخطاب الفلسفي - العولمة